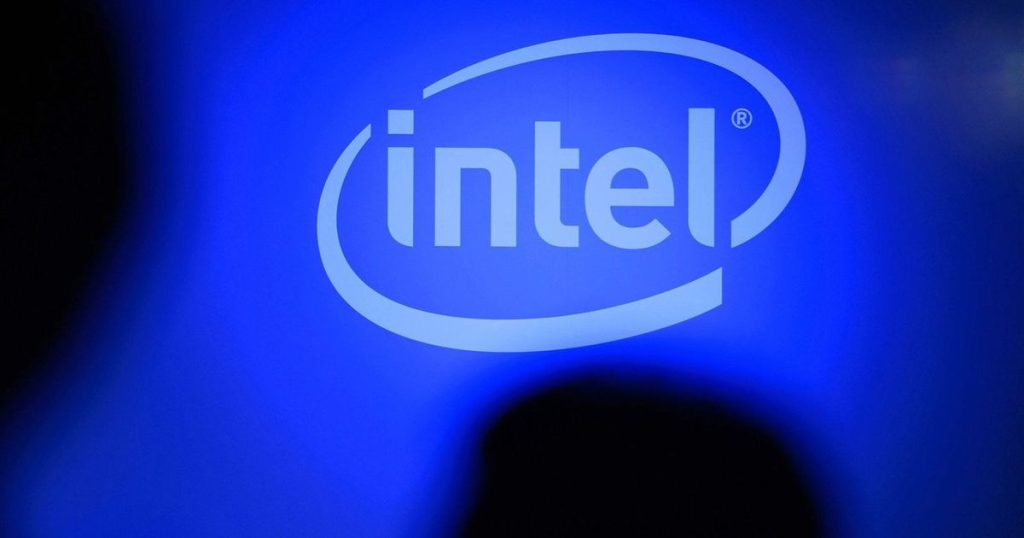منذ تأسيسها في أواخر ستينيات القرن الماضي، جسّدت “إنتل” (Intel) قصة صعود صاروخية جعلتها رمزاً للتفوق التكنولوجي الأميركي و”وجه وادي السيليكون”، فقد قادت ثورة الحواسيب الشخصية بمعالجاتها الدقيقة التي أصبحت الأساس الذي بُنيت عليه عقود من الابتكار في عالم الحوسبة.
مع مرور الزمن، لم تعد “إنتل” مجرد شركة خاصة أو منافس تقني، بل تحولت إلى ورقة استراتيجية على طاولة الدولة الأميركية. فهي تمثل ركيزة في سباق الرقائق العالمي، وعنصراً محورياً في أمن واشنطن الوطني، وأداة حاسمة في تقليل الاعتماد على تايوان والصين. من هنا، يتجاوز الاهتمام الحكومي مصير شركة بعينها، ليعكس رهانات كبرى على مستقبل التكنولوجيا الأميركية نفسها.
إقرأ أيضاً: “سوفت بنك” تشتري أسهماً في “إنتل” بملياري دولار في صفقة مفاجئة
وسنتناول في هذا الموضوع مسيرة الشركة منذ انطلاقتها وابتكاراتها مثل “قانون مور”، إلى مراحل التراجع وفقدان العرش لصالح منافسين كـ”إنفيديا” (Nvidia) و”تي إس إم سي” (TSMC)، ثم نوضح لماذا تحولت إلى ملف استراتيجي على طاولة الإدارة الأميركية ومعركة إنقاذها الراهنة.
كيف بدأت قصة الشركة برحلة نجاح صاروخية؟
في أواخر ستينيات القرن الماضي، انطلقت “إنتل” برؤية مبتكرة على يد روبرت نويس وجودون مور، مدعومة بتمويل من المستثمر آرثر روك، لتصبح سريعاً أحد أبرز اللاعبين في صناعة أشباه الموصلات. نجاحها المبكر ارتبط بابتكارات ثورية مثل أول شريحة ذاكرة تجارية (1103) عام 1970، ثم المعالج الدقيق (4004) عام 1971، الذي مهد الطريق لانتشار الحواسيب الشخصية. ومع اختيار “آي بي إم” (IBM) لمعالجات “إنتل” في كمبيوتراتها عام 1981، تحوّلت الشركة إلى ركيزة أساسية في الثورة التقنية الحديثة، ورسخت مكانتها كقوة مهيمنة على سوق المعالجات الدقيقة بفضل معمارية (x86) التي أصبحت معياراً عالمياً.
ووصف موقع “تيك تارجت” (TechTarget) هذا التحول الاستراتيجي من صناعة الذاكرة إلى المعالجات الدقيقة بأنه نقطة الانعطاف الحاسمة التي ضمنت لـ”إنتل” موقع الريادة في عالم الحوسبة.
منح “إنتل” 20 مليار دولار يكشف مواطن الضعف الأميركية… التفاصيل هنا
حتى العقد الأول من الألفية، كانت “إنتل” القوة المحركة وراء الحوسبة حول العالم، وفقاً لوصف صحيفة “إس إف غيت” (SFGate) بأنها كانت “وجه وادي السيليكون”، حيث ارتبط اسمها بعصر الحواسيب الشخصية الذي اجتاح المنازل والشركات على حد سواء.
تحت قيادة آندي غروف، شهدت الشركة نمواً هائلاً في قيمتها السوقية وتوسعت عالمياً، مستفيدة من شراكتها غير الرسمية مع “مايكروسوفت” التي شكلت ما عُرف لاحقاً بتحالف “وينتل” (Wintel). وبحسب “إس إف غيت”، فقد مكنها هذا التفوق التقني والتجاري من السيطرة على أكثر من 80% من سوق المعالجات الدقيقة في التسعينيات، ما جعلها رمزاً لهيمنة وادي السيليكون على التكنولوجيا العالمية.
ورغم هذا النجاح الساحق، كانت فلسفة آندي غروف الشهيرة “فقط البارانويدون ينجون” (Only the paranoid survive)، أي أن الشركات والأفراد الذين يعيشون في حالة يقظة دائمة وقلق صحي تجاه المخاطر والتغيرات المحيطة هم الأكثر قدرة على التكيف والنجاة، بمثابة البوصلة التي وجهت “إنتل” نحو الاستمرار في الابتكار وعدم الركون إلى التفوق القائم.
وبحسب “إس إف غيت”، ساعد هذا النهج القائم على الحذر المستمر من المنافسين والتغيرات التقنية الشركة على تجاوز أزمات حادة، وأرسى ثقافة داخلية تعتبر أن الخطر الكامن في الأفق هو الدافع الأكبر للنمو والابتكار.
ما هو قانون مور الذي وضعه مؤسس “إنتل”؟ وما دوره في الذكاء الاصطناعي؟
قانون مور (Moore’s Law) هو مبدأ صاغه جوردون مور، أحد مؤسسي “إنتل”، عام 1965 في مقال نشرته مجلة “إلكترونكس” (Electronics Magazine). ينص القانون بصيغته الأصلية على أن عدد الترانزستورات التي يمكن وضعها على شريحة إلكترونية يتضاعف تقريباً كل عامين، ما يؤدي إلى زيادة هائلة في القدرة الحاسوبية مع انخفاض التكلفة لكل عملية حسابية، بحسب موقع “انفستوبيديا” (Investopedia).
هذا القانون لم يكن مجرد توقع تقني، بل أصبح خريطة طريق لصناعة أشباه الموصلات لعقود. الشركات الكبرى -من “إنتل” نفسها إلى “تي إس إم سي” و”إنفيديا”- اعتمدت على قانون مور في تخطيط أجيال جديدة من الشرائح، بحيث يُترجم التطور إلى أجهزة أصغر حجماً، وأسرع أداءً، وأرخص سعراً.
اليوم، يُعتبر قانون مور حجر الزاوية في الذكاء الاصطناعي، إذ إن مضاعفة القدرة الحاسوبية باستمرار مكّن من تدريب نماذج ضخمة ومعقدة تحتاج إلى مليارات المعاملات. ورغم أن بعض الخبراء يرون أن القانون يقترب من حدوده الفيزيائية بسبب قيود تصنيع الترانزستورات على مستوى النانومتر، فإن الاتجاه نحو تقنيات بديلة مثل المعالجات المتخصصة (GPUs, TPUs) والمعمارية ثلاثية الأبعاد يحافظ على روح قانون مور ويمد أثره في عصر الذكاء الاصطناعي.
كيف ومتى هبطت الشركة عن عرش الرقائق؟
في بداية الألفية (2000–2006) واصلت “إنتل” (Intel) هيمنتها على سوق معالجات الحواسيب المركزية، لكنها تجاهلت التغيرات التي بدأت تلوح في الأفق مع تطور وحدات معالجة الرسوميات (الجرافيكس). ففي الوقت الذي ركزت فيه “إنتل” على تحسين قدرات وحداتها المركزية، كانت “إنفيديا” (Nvidia) تطور معالجات رسومية متقدمة أثبتت فعاليتها خارج حدود الألعاب، خصوصاً في مجالات الحوسبة المتوازية. وبحسب موقع “تيك تارجت” (TechTarget)، فإن هذا التحول المبكر كان مؤشراً على أن المنافسة لن تظل محصورة في سوق المعالجات التقليدية.
وفي الفترة من (2006–2010) بدأت “إنفيديا” توسع نطاق وحدات معالجة الجرافيكس لاستخدامها في تطبيقات الحوسبة عالية الأداء (HPC)، ما شكل تحدياً غير مباشر لوحدات المعالجة المركزية التي تقودها “إنتل”.
أشارت صحيفة “إس إف غيت” (SFGate) إلى أنه في هذه المرحلة ظهرت بوادر انتقال ميزان القوة في صناعة الرقائق، حيث باتت قدرات المعالجة المتوازية التي تقدمها “إنفيديا” تفتح أبواباً جديدة للحوسبة العلمية والبحثية.
في الأعوام 2010حتى 2015 ثبُت تفوق وحدات معالجة الجرافيكس مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، إذ وفرت معالجات “إنفيديا” بنية مثالية لتدريب الشبكات العصبية، في وقت لم تستطع فيه “إنتل” منافسة هذه القفزة بالاعتماد فقط على معالجاتها المركزية. وبحسب “تيك تارجت”، فإن هذا التحول الاستراتيجي جعل وحدات الجرافيكس أداة لا غنى عنها في مجالات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
قد يهمك أيضاً: “إنتل”: فصل وحدتي التصنيع والتطوير لا يزال أمراً غير محسوم
أما في الفترة من 2015 إلى 2020 فقد تسارعت المنافسة بشكل أوضح. وبينما كانت “تي إس إم سي” تدعم شركات مثل “إيه إم دي” (AMD) و”إنفيديا” بتقنيات تصنيع متقدمة، تأخرت “إنتل” في إطلاق أجيال جديدة من وحداتها المركزية. هذا التأخر، كما أوضحت “إس إف غيت”، عزز مكانة وحدات الجرافيكس كلاعب رئيسي في السوق، لتتحول من مجرد مكون مساعد إلى منافس مباشر.
وفي الأعوام من 2020 إلى 2023 قفزت القيمة السوقية لـ”إنفيديا” مدفوعة بالطلب الهائل على وحداتها الرسومية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتدريب النماذج اللغوية الضخمة، في وقت كانت “إنتل” تعاني إخفاقات متتالية في تطوير تقنيات تصنيعها عند مستوى 7 نانومتر. وبحسب “إس إف غيت”، فقد فقدت الشركة بذلك موقعها القيادي لصالح “إنفيديا” التي باتت تتصدر الابتكار والسوق.
ومنذ 2023 حتى عامنا هذا، أصبحت “إنفيديا” في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي بفضل وحدات معالجة الجرافيكس التي أضحت منافساً مباشراً لوحدات المعالجة المركزية. في المقابل، تسعى “إنتل” اليوم إلى إعادة بناء قدراتها عبر استثمارات ضخمة ودعم حكومي ضمن “قانون الرقائق”، لكن السباق على الريادة يبدو وكأنه انتقل فعلياً من المعالجات المركزية إلى وحدات الجرافيكس.
تبلغ القيمة السوقية لشركة “إنفيديا” حالياً نحو 44.4 تريليون دولار، في حين لا تتجاوز قيمة “إنتل” 103.5 مليار دولار، أي أن قيمة الأولى أكبر بحوالي 42.5 مرة من “إنتل”.
لماذا تهتم إدارة ترمب بهذه الشركة؟
ترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن “إنتل” تمثل ركناً أساسياً من الأمن الوطني الأميركي في مواجهة الصين. فالرقائق الدقيقة ليست مجرد منتجات استهلاكية، بل مكوّن حيوي في الذكاء الاصطناعي والتجهيزات العسكرية المتقدمة، ما يجعل الحفاظ على قوة الشركة ضرورة استراتيجية. وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن أي تراجع في مكانة “إنتل” يعني خسارة واشنطن لنفوذها في واحدة من أكثر الساحات حساسية في الصراع التكنولوجي العالمي.
وتجري إدارة ترمب محادثات للاستحواذ على حصة تبلغ نحو 10% في شركة “إنتل”، عن طريق تحويل بعض أو كل المنح التي حصلت عليها الشركة بموجب “قانون الرقائق والعلوم” الأميركي إلى أسهم، وهي خطوة قد تجعل الحكومة الأميركية أكبر مساهم في شركة صناعة الرقائق المتعثرة.
في الوقت نفسه، يخدم دعم “إنتل” أجندة ترمب الاقتصادية القائمة على إعادة التصنيع إلى الداخل. فالشركة، بخلاف معظم منافسيها، ما زالت تحتفظ بقدرات تصنيع متقدمة داخل الولايات المتحدة، وهو ما يضعها في قلب خطط “قانون الرقائق” الذي تسعى الإدارة إلى استغلاله لتمويل مصانع جديدة وضمان استقلالية سلاسل التوريد.
صحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times) أشارت إلى أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تقليل الاعتماد على تايوان، التي تمثل نقطة ضعف جيوسياسية للولايات المتحدة.
إقرأ المزيد: “TSMC” التايوانية تدرس الاستحواذ على حصة مسيطرة في “إنتل” بطلب من فريق ترمب
إلى جانب ذلك، تتابع الإدارة الأميركية بقلق صعود “إنفيديا” (Nvidia) و”إيه إم دي” (AMD)، وما يرافقه من انحسار نفوذ “إنتل” داخل السوق الأميركية نفسها. هذا الواقع دفع واشنطن إلى التفكير في خطوات غير تقليدية، مثل شراء حصص مباشرة في الشركة أو حتى إشراك “تي إس إم سي” (TSMC) في إنقاذها، وفق ما أوردته صحيفة “ذا تايمز” (The Times). هكذا تحولت “إنتل” من مجرد شركة خاصة إلى ملف استراتيجي على طاولة الدولة، يجمع بين الاقتصاد والجغرافيا السياسية والأمن الوطني.
معركة إنقاذ إنتل: صراع القيادة وتدخل الدولة
تعيش “إنتل” (Intel) واحدة من أكثر المراحل دراماتيكية في تاريخها، حيث تداخلت الأزمات الداخلية مع التدخلات السياسية الأميركية في محاولة لإنقاذ عملاق الرقائق من فقدان موقعه العالمي. البداية كانت في ديسمبر 2024 حين أُجبر الرئيس التنفيذي السابق بات غيلسنجر على التقاعد بعد سنوات من الأداء المتراجع، ليتسلم في مارس 2025 المخضرم ليب بو تان القيادة، وهو المعروف بخبرته في قطاع أشباه الموصلات.
بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”، طرح تان فور وصوله أفكاراً لإعادة هيكلة الشركة تضمنت تقسيمها إلى وحدات مستقلة وخفض آلاف الوظائف بهدف تقليص التكاليف وتعزيز الكفاءة.
لكن مسيرة الرئيس التنفيذي الجديد لم تكن سهلة. ففي أغسطس 2025، اصطدم تان سريعاً بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي دعا علناً إلى استقالته بسبب خلافات حول الاستراتيجية، خصوصاً ما يتعلق بمستقبل التصنيع داخل الولايات المتحدة. غير أن ترمب عاد بعد أيام قليلة، في منتصف أغسطس، ليغيّر موقفه بشكل مفاجئ عقب اجتماع مباشر مع تان، في تحول لحجم الضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بمصير الشركة.
أشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن هذا التحول في الموقف يعكس إدراك الإدارة الأميركية لأهمية بقاء “إنتل” قوية ضمن صراع الرقائق مع الصين.
وبالتوازي مع تلك التطورات، تشكل خطوات الحكومة لدعم “إنتل”، بحسب “وول ستريت جورنال”، تحولاً جذرياً في علاقة الدولة بالشركات التكنولوجية الكبرى، وتؤكد أن معركة الرقائق باتت قضية أمن وطني وليست مجرد منافسة تجارية.